جميلةٌ هي القصَّة، قريبةٌ من الوجدان، ومحبَّبةُ إلى النَّفس، وحين تُعرَض شخصياتها بإحكامٍ وإتقان، وتُدرس أفكارها بحكمةٍ ودقّة؛ تؤتي ثمارها بيسرٍ وسهولةٍ.
لا شكَّ أنَّ لكلِّ كاتبٍ رؤيته الخاصَّة، ولكلِّ عملٍ فنّيٍّ رسالة وهدف، منها النبيل ومنها عكس ذلك، فثمَّة من يستميت لزراعة الشوك والحنظل والصبَّار، ويبثُّ السمَّ في العسل، فيكرِّس وقته، وجهده، وفكره، وإبداعه في سبيل ذلك.
دعونا ندرج الروايات والقصص بأشكالها -سواء كانت مقروءة، أو مرئية، أو مسموعة- تحت بند الفنّ الترفيهي، وهو أمرٌ لستَ ملزماً بممارسته، لكنَّك تلجأ إليه لتروِّح به عن نفسك، وتطَّلع على عوالم مختلفة، فتوسِّع أفقك.
على أيامنا –نحن جيل الثمانينيات والتسعينيات- كانت تلك الأعمال أمراً ثانوياً ومحدوداً. فالمقروء منها، هو ما وُجِدَ في مكتبة البيت، أو ما استطعنا استعارته من مكتبات أصدقائنا وأقربائنا، أمَّا المسموع والمرئي؛ فهو ما يصدر عن الإذاعة والتلفاز، من مسلسلات وأفلام، وهي محدودة بطبيعة الحال، وتُعرَض بحضور أفراد العائلة كافَّة.
اختلف الأمر كثيراً هذه الأيام، وبات مثيراً للقلق! فلكلِّ فردٍ من أفراد العائلة جهازه الخاصّ، يقرأ ويسمع ويشاهد ما يشاء، ومتى يشاء.
وفي ظلِّ هذه التطورات الحاصلة وإمكانية استعراض “كلّ” المنتجات عبر شبكة الانترنت، بتنا بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى أن نولي فئة “اليافعين” اهتماماً كبيراً وعنايةً واسعة وحمايةً شاملةً.
ومن الجدير بالملاحظة أنَّ “اليافعين” هذه الأيام ينقسمون إلى شريحتين أساسيتين: إمَّا قارئ نهم، أو يافعٌ غير مهتمٍّ بالقراءة وبالكاد يقرأ كتبه المدرسيَّة، أمَّا الشريحة المتوسِّطة بينهما، فلم تعد هي الأغلبية كما في العادة. ونتيجةً لذلك، نجد أنَّ القارئ اليافع، لن يكتفيَ بقراءة الأدب المخصص لليافعين فقط، إذ لديه نهمٌ شديدٌ للقراءة، ممَّا يجعله يتقدَّم خطوةً إلى الأمام ويبدأ بمطالعة الأعمال الأكثر تعقيداً والمقدَّمة للراشدين بطبيعة الحال.
وفي هذا السياق، يتعيَّن على من يكتب ويؤلِّف منتجاتٍ أدبيَّة للـ”الراشدين”، أن يأخذ بعين الاعتبار أنَّ عمله قد يصل إلى أيدي اليافعين، وحتَّى لو لم يلم اليافع بكلِّ الأفكار والمعاني، ولم يصل إلى العمق الكامل وراء رسالة العمل، إلا أنّه ومن المهم ضمان أنَّ المنتج القصصي أو الفنّي لن يسبب أيَّ أذىً غير محسوبٍ من خلال ترويج الأفكار العقائدية المنحرفة، والتطبيع مع الانحرافات بكلّ أطيافها، وإشاعة القسوة والعنف والمشاهد الخادشة للحياء.
ويكمن السؤال الأهمّ: “هل نحن ملزمون بتوفير البدائل؟ ولماذا؟”
يطرح الكاتب سامي فسيح في مقالته: “البديل الشرعي وضعف الانقياد..” سؤالاً مهمَّاً ومحوريَّاً: “هل يلزم الشرع الإتيان بالبدائل في أمور الترفيه؟”
ويسرد بعدها جواباً منطقياً وواضحاً يغطِّي محاور عديدة: “قد تتدخل الشريعة ببديل مباح في أمور الترفيه إذا كان فيها ما يُستَنكر، إلا أنه لا يلزمها الإتيان دائما بالبدائل المسموح بها شرعاً لكون باب الترفيه من الأبواب الواسعة والمتجددة في الزمان والمكان، فهو مجال واسع للإبداع البشري لم يقيده الشرع إذا كان في إطار المباح…”، “إن الترفيه إذن من أمور الدنيا المباحة ما دامت تحترم الضوابط الشرعية، والشرع لا يقيدها إلا إذا بدا له فيها قفز إلى جهة الممنوع شرعاً، وقد قال رسول الله ﷺ في قصَّة تأبير النخل أنتم أعلم بأمور دنياكم، وما أحلى الترفيه إذا كان يخدم قضايا الأمة الإسلامية، وينطلق من ثوابتها وأصولها باعتبارها ركائز يبنى عليها الترفيه.” [1]
أوافقه الرأي، فنحن لا نتحدَّث هنا عن بديلٍ لسدِّ الجانب الترفيهي فقط، إنَّما بغرض الاستفادة من تلك الأداة، لإعادة التطبيع مع الأفكار والمبادئ والقواعد السليمة، ووسيلة لعرض واقعٍ حيِّ وعمليٍّ للقيم والمفاهيم النظرية التي نسعى إلى نشرها.
فنحن –على سبيل المثال- بحاجةٍ إلى إحياء صور أكثر نُبلاً وانضباطاً واحتراماً للعلاقة بين الرجل والمرأة، بهدفها، وشكلها، ومضمونها، وحدودها، إذ إنّ التشويه الحاصل في السنوات الأخيرة وصل إلى مرحلةٍ غير مقبولةٍ بتاتاً، ونتيجةً لذلك، علينا أن نهدم أولاً ما تمّ تطبيعه في أذهان الجيل الجديد ومن ثمَّ نعيد بناء صورة معتدلة وطبيعية، لعلَّنا نساعدهم على إيجاد إجابات لأسئلةٍ كـ: لماذا نتزوج؟ لماذا علينا أن نكوِّن أسرة؟ هل المرأة مسؤولة عن خدمة الرجل؟ هل يحقُّ للرجل أن يدير شؤون الأسرة؟ هل؟ هل؟ هل….
تلك الأسئلة التي غدت كمعضلاتٍ غير قابلة للحلِّ نتيجة التشويش والتشويه المتعمَّد من قبل الحركات النسوية، و”شريعة” التنمية البشرية التي تؤكِّد مبدأ الفردانية، وعدم ضرورة الإصلاح الذاتي، وتؤصِّله بشعاراتٍ ما أُريد بها إلا الباطل:
لا تخض أي تجربة قد تزعجك!
لا تجبر نفسك على التغيير للأفضل!
كن كما أنتَ بمساوئك ولا تستمع للآخرين!
البدائل المتاحة
إذا بحثنا في الأعمال المطروحة على أنَّها بدائل سنجد أنَّ أغلبها يتمركز حول المحورين التاليين: التاريخي أو الديني، وبالتأكيد فإنَّ ثمة إشكالية كبيرة في الاقتصار على هذين المحوريين فقط!
فالأعمال التاريخيَّة، الحقيقة منها والخيالية، هي أعمال جيِّدة وتحمل في طيَّاتها كثيراً من العبر والصور المُشرقة، لها فوائدها في توضيح المفاهيم والأصول الأساسيَّة بعيداً عن تعقيدات المجتمع الحديث، كما لا يمكن إنكار دورها في تعزيز الانتماء والفخر، لكن ورغم ذلك لا يمكن اعتبارها بديلاً متكاملاً، فهي تطرح المُشكلات بقالبٍ قديمٍ، حتَّى لو أُسقِطَت واستُمدَّت من الواقع الحالي، إذ تبقى أدوات الحلّ وثقافة الشخصيَّات، وأنماط تفكيرها، متناسبة مع حقبةٍ قديمةٍ، ومجدَّداً يجد القارئ نفسه بعيداً عن الشخصيات، وليس قريباً إليهم بما يكفي لاتِّخاذهم نموذجاً متكاملاً يعبِّر عنه أو يمثِّله.
أمّا عن الأعمال الدينية، فالتصنيف بحدِّ ذاته غير مفهومٍ بالنسبة لي، إذ لا وجود له على أرض الواقع! كيف يكون العمل دينياً؟!
قد تُقدَّم قصَّة قصيرة للأطفال الصغار تحكي عن فضل الأمانة، والصدق، والإيثار، والأخلاق الحميدة كافَّة، وتأخذ انطباعاً دينياً عامَّاً، فتظهر الأمُّ في القصَّة محجَّبةً طوال الوقت، وذات خُلقٍ وحكمةٍ، لغتها لطيفة للغاية ومفرداتها منتقاة بعناية، ونجدها تكرِّر: زوجي الصالح، ابني العزيز، وما إلى ذلك، لسانها يلهج بالذكر والدعاء، وابتسامتها لا تفارق شفتيها، أمَّا الأب، فما إن يصل إلى المنزل، حتَّى ينغمس ويعاون أهل البيت فيما هم فيه، بابتسامةٍ ورضا وصفاءٍ ونقاء…
أجد أنَّ بناء شخصياتٍ كتلك في قصَّةٍ قصيرةٍ موجَّهةٍ للأطفال هو طرحٌ مقبولٌ نسبياً، لكن في الأعمال التي تستهدف الشريحة الأكبر سناً، يصبح الأمر شائكاً بعض الشيء، إذ لا يمكننا تقديم شخصية كاملة متكاملة، لا تخطئ، وإلا سنقع في فخ الشخصيّة المثالية، والتي سنتطرَّق إليها لاحقاً.
ومع هذا وذاك، ورغم أنَّ الساحة الأدبية والفنيّة لا تخلو من الأعمال البديلة ضمن التصنيفات الاجتماعية والعاطفية والدراما، إلا إنَّ نسبتها ضئيلة مقارنةً مع الحاجة الكبيرة والملحّة.
نقاط الضعف والأخطاء المتكرِّرة في البدائل المتاحة في التصنيفات الاجتماعية
دعونا في البداية نتفق على الأمور التالية، وهي أنَّ القارئ:
-
- ذكيُّ للغاية.
- يملُّ من الرسائل المباشرة.
- يقرأ الرواية بدافع الاستمتاع في المقام الأول، ومن ثمَّ تلقي الحكم والعبر، وفي كلِّ الأحوال هو لا يقرأ الرواية بهدف نهل العلم والمعرفة.
- لديه خبرة جيدة في تحليل الشخصيات والحبكات والأحداث.
- يكشف الثغرات والمشكلات في الأحداث والسرد.
بناءً على ذلك، هناك مجموعة من الأخطاء المتكرِّرة في عرض الشخصيات، والحبكات، وطريقة معالجة الأحداث في تلك البدائل، من شأنها إضعاف العمل، وضرب سمعة البدائل، مما يسبب أذىً أكبر من فشل روايةٍ أو عمل واحد، فالقارئ حين ينفر من عملٍ طُرح على أنّه بديلٍ هادف، هو في الأغلب سيتجنّب هذا الباب ظنّاً منه أنّ جميع ما يقدَّم لن يرقى إلى المستوى المطلوب.
سنستعرض بعض تلك الأخطاء، سعياً منَّا إلى تحسين جودة البدائل، وجعلها تشدُّ النفوس إليها بدلاً من أن تسدَّ الأبواب إليها، وأنا هنا لن أمرَّ على الأخطاء الشائعة والتي قد يقع فيها الكاتب القصصي في العموم، كالإفراط في تقديم شخصيات كثيرة مع تفاصيلها، والحشو والإسهاب من غير ضرورة، وما إلى ذلك.
تحميل الرواية فوق طاقتها
من يشرع لتقديم عملٍ هادفٍ، يكون في العادة متحمِّساً ويرغب في تحقيق الاستفادة القصوى من مادَّته القصصية، وقد ينتج عن تلك الرغبة النبيلة، أن يحمِّل الكاتب روايته فوق طاقتها، مما يجعلها تبدو مثل كتاب فكريّ، أو مقالة مطولة، فتخسر جوهرها الفنّي وينتزع منها العامل الأساسي الذي يجذب القرَّاء، ناهيك عن تشتيت القارئ بكثرة المحاور والأفكار المطروحة والمُعالَجة، فيفقد بذلك تركيزه في الرسالة الأساسية للعمل.
عدم توازن الأفكار مع الأحداث
عندما يبالغ الكاتب في الأفكار التي يودُّ عرضها خلال روايته، يصبح تركيزه الأساسي على تلك الأفكار والرسائل التي يودُّ ترسيخها على حساب الحبكة وسلاسة الأحداث، وفي هذه الحالة يصاب القارئ بالملل الشديد حين يعمد الكاتب إلى استغلال كلِّ موقف وحدثٍ لزجّ رسالةٍ أو حكمةٍ، بل نسج الموقف بشكلٍ مفتعلٍ وغير ناضج ليناسب الفكرة التي يودُّ عرضها.
نعم، إنَّ الهدف من العمل الفنيّ توجيه الرسائل والعبر، لكن يتعيَّن على الكاتب أن يتحلّى بالصبر والأناة، وألا يشعر بالخسارة من سرد حالةٍ وجدانيةٍ بتفاصيل كثيرةٍ وحبكةٍ مدروسةٍ بعنايةٍ من أجل جزئية صغيرة تخدم الفكرة التي يودُّ إيصالها.
الإفراط في توظيف “الأحداث ذات الاحتمال المركّب”
دعوني أولاً أعرِّف “الحدث ذا الاحتمال المركَّب”، وهو حدثٌ صُمِّم خصيصاً لتحريك الحبكة باتجاهٍ معيَّن. يعتمد هذا الحدث على الصُّدَف المتتالية، صُدَفٍ نادرة الحدوث وصعبة التحقق بالتسلسل المطروح، وحتَّى يكون العمل مقنعاً، والحبكة قوية، على الكاتب أن يتخفَّف قدر الإمكان من تلك الأحداث المركّبة.
استسهال لحظة الاستنارة
يميل بعض الكتَّاب إلى جعل لحظة الاستنارة للشخصية حدثاً محفوفاً بالدراما والغموض والتساؤلات الجوهرية، فنجدهم يستعينون بحلمٍ غامضٍ، أو حادثةٍ مؤلمةٍ، أو نصيحةٍ من شخصٍ غريبٍ أو من طفلٍ بريءٍ، أو رسالةٍ مجهولة المصدر وما إلى ذلك. في الواقع، يمكن للكاتب أن يستخدم تلك الأدوات كعاملٍ مساعدٍ للحظة التنوير، لكن بعد أن يهيئ الشخصية بتروٍّ وإتقانٍ، لا أن يزجَّ بها فجأة في السياق، فتُنار الطرق، وتُزال الحجب، فيشعر القارئ بأنَّ الكاتب استسهل باستخدام تلك التقنيات، ولم يبذل جهداً واضحاً للوصول إلى حالة الاستنارة للشخصية المعنية بالأمر.
تحويل المنهج الفكريّ إلى حوارٍ بين الشخصيات
يعتقد البعض أنّ تحويل السرد إلى حوار يجعل العمل بالضرورة أجمل أو أكثر إمتاعاً، أيّاً كانت تلك فكرة الحوار، وهذا غير صحيح على الدوام، فتقطيع الفكرة المباشرة، وسردها بقالبٍ حواريٍّ بين الشخصيات، لن يحولها إلى فكرةٍ غير مباشرة، وستبقى فجَّةً ومصطنعةً وضعيفة التأثير. وفي المقابل، حين يُسرد حديث النفس في مكانه الصحيح يكون ماتعاً ومؤثِّراً، كذلك الأمر حين يستطرد الكاتب بوصف حالٍ ما لحدثٍ أو لشخصية في سياقه المناسب، يأتي الوصف حينها غنيَّاً وشائقاً.
فخ الشخصيّة المثالية
مجدداً، من أكبر الأخطاء في الطروحات البديلة، هو تقديم شخصيَّة مثاليَّة، تتصرَّف دوماً بطريقةٍ صحيحةٍ، وبردَّة فعل حكيمة، ورباطة جأش عالية المستوى، وحسن خلق مبالغ فيه، وهذه الشخصيات وإن وُجدت في الواقع، فهي نادرة جدّاً، ونجد بأنَّ بعض الكتَّاب يميلون لتقديم شخصيَّة مثاليَّة، ظنَّاً منهم بأنَّهم بذلك يقدِّمون الصورة الصحيحة لتغدو قدوة لا تشوبها شائبة ولا يخالطها عيب، لكن ما يحدث هو أنَّ القارئ يُصاب بخيبة أمل، ويشعر بحالة انفصالٍ عن الواقع، وبُعد وجفاء عن الشخصية، فلا يستطيع اتخاذها قدوة كونها مثاليّة، ولا يشعر بحالة تقارب وجدانية معها.
ويظهر أنَّ كثيراً من الكتّاب باتوا يتجنَّبون هذا الفخ في الآونة الأخيرة، إلا إنَّ بعضهم يتجنَّبونه بطريقةٍ شكليَّةٍ بحتةٍ عبر نثر حبَّاتٍ من العيوب الظاهريّة على الشخصية “شبه المثالية”، والقارئ كما اتفقنا: ذكيّ للغاية!
استبعاد النموذج “الاعتيادي”، أو تقديمه كنموذج ساذج بعض الشيء
لا يمكن نشر ثقافة مجتمعٍ ما عبر الأعمال التي تأتي منحازةً لصالح أنماط محدودة في المجتمع، فتوحي للمتلقي كما لو أنَّ المجتمع بأكمله ينتمي إليها. في حين أنَّ أغلب المجتمع لا يمتُّ لها بِصلةٍ، فنحن حين نقرأ أو نسمع أو نشاهد قصةً أو حكايةً، نبحث عن أناسٍ يشبهوننا، وعن جملةٍ تمسُّ شيئاً بداخلنا، وعن جوابٍ لسؤال لطالما حيَّرنا، لكن كيف السبيل إلى ذلك مع تلك الطروحات التي تعرض من المشكلات أعقدها، ومن الشخصيات أكثرها ندرة؟!
نحن بحاجةٍ إلى أن نفسح المجال للنموذج “الاعتيادي”، بطموحاته الطبيعية، وعقباته الروتينيَّة ليعبِّر بوضوح عن نفسه، نموذجٌ لا هو ينتمي إلى عالم الشرِّ السفلي، ولا إلى عالم الفضيلة المثالي، تُعرَض مشكلاته التي قد تبدو بسيطة -نظراً لتكرارها- إلا إنَّها تشكِّل تحدِّياً، وتحتاج إلى معالجةٍ وتفنيدٍ وتحليلٍ.
ومن الملاحظ أنَّ النموذج الاعتيادي يظهر في بعض الأعمال البديلة ساذجاً بشكلٍ عجيب، وغير مدركٍ لما حوله بطريقةٍ غريبةٍ، وهذا مجدَّداً لا ينفع، ولا يؤتي ثماراً.
ضعف البدائل في التصنيفات الجذّابة لليافعين
على الرغم من محاولات كتّاب من الطراز الرفيع لسدّ الحاجة في بعض التصنيفات القصصية والروائية، إلا أنّ البدائل في بعضها الآخر غير متاحة، ولا سيما: الفانتازيا، والخيال العلمي، أمَّا في التصنيف العاطفي والذي يتناول علاقة الرجل بالمرأة، فنجد أنَّ أغلب البدائل تحذو حذو الطروحات التقليدية الأخرى، إذ تنتهي القصَّة عند لحظة الارتباط الرسميّة، كالأفلام والمسلسلات والروايات العالمية!
وبرأيي، يجب ألا تكتفي تلك الطروحات بالتركيز على: جهاد النفس والتعفُّف في مرحلة ما قبل الزواج، بل عليها أن تكمل الحكاية، فباكتمالها تصل رسالة مهمَّة وهي أن يدرك القارئ -وبالذات اليافع- أنَّ لحظة الارتباط الرسميّ في قصّة أي زوجين، إنَّما تتوضع في اللحظات الأولى من قصّتهما، وهي جزء بسيط من سيرتهما، وتقييم العلاقة بينهما يكمن بعد الزواج.
من يقدِّم البديل؟
في مقالته: “تقنية الثقافة.. كيف تُصدِّر الشعوب ثقافتها؟ التجربة الكورية نموذجاً!”، يتساءل الكاتب أحمد محمد حسن: “ما الذي يمنعنا نحن المسلمين من نشر ثقافتنا للشعوب الأخرى؟” [2]
وسأجيبه: الجرأة والمبادرة! فحين نتحدَّث عن تقديم عملٍ ما كبديلٍ للقراء، أو بهدف نشر ثقافتنا عالمياً، فنحن نتحدَّث عن رسالةٍ هادفةٍ، وراقيةٍ، وساميةٍ، وبطبيعة الحال، ليس من المتوقع أن يُقَدَّم البديل من قبل الفئات التي لا تحمل هذه الرسالة بالأساس!
ممَّا يعني أنَّنا بحاجةٍ إلى كتّابٍ يحملون على عاتقهم الالتزام بتقديم محتوىً آمن وهادف، وفي الوقت ذاته يملكون المهارات والمواهب والتقنيات اللازمة لخوض هذا المضمار وسدّ تلك الثغرات، كتّابٍ يجتمع لديهم الفكر، والوعي، والعلم، والفنّ، والإبداع. وللأسف، قد يأنف البعض من توظيف علمه وفكره في تقديم رواية، وهذا خطأ كبير! إذ لا يمكن الاستهانة بهذا الباب كما أوردنا سابقاً، كما لا يمكن الزهد فيه وإفساح المجال الكامل لمن لا يملكون الرؤية الواضحة بأن يعبثوا بأفكار الناس ومشاعرهم كما يشاؤون.
نحن بحاجةٍ إلى الجرأة في اقتحام عالم الفنون القصصيَّة والروائيَّة بكلِّ أشكاله، وقوالبه، وتصنيفاته، وإلى الإصرار والمثابرة، والإيمان بأنّ هذا الجيل يستحق أن نقدِّم له أحسن الأعمال وأجودها، خاصّة أنَّهم وُلدوا في عصرٍ يتبارى فيه أصحاب الأموال والنفوذ والقرار في إفسادهم عبر كلِّ الوسائل والأساليب المتاحة.
بقلم.. سحر خواتمي
المراجع
[1] البديل الشرعي وضعف الانقياد.. حول الأنمي من جديد، سامي فسيح.
[2] تقنية الثقافة.. كيف تصدِّر الشعوب ثقافتها؟ التجربة الكورية نموذجاً!، أحمد محمد حسن.

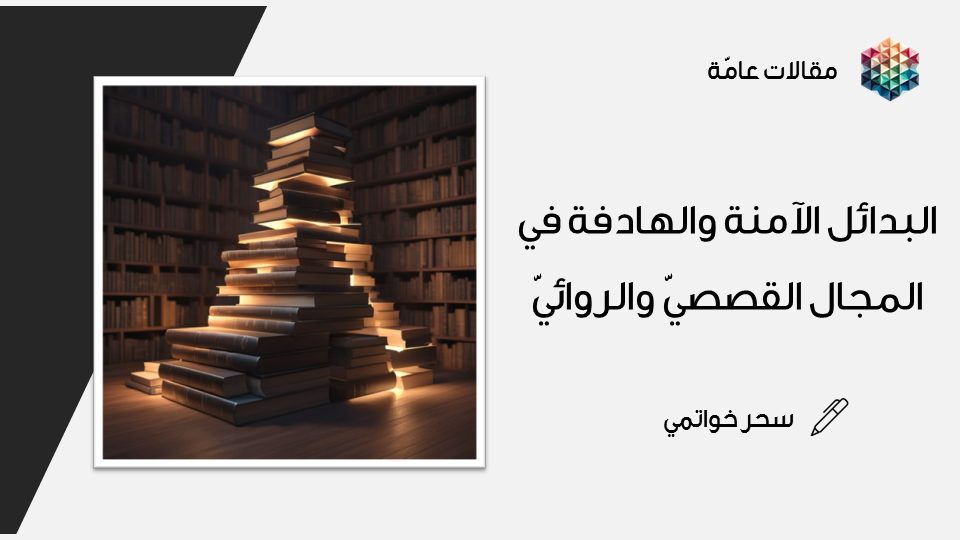
مقال تخصصي يصلح لأن يكون تأصيلا لفن الرواية الآمنة والهادفة
يعالج كثيرا من النقاط المهمة والأخطاء الشائعة فنيا وذوقيا وفكريا في أدب الرّواية
أرجو أن يصل هذا المقال إلى كل روائي وأعتقد بأن تطبيق ما فيه سيكون له أثر على رفع سويّة الكتابة في هذا المضمار
بورك القلم والعقل
أهلاً بتول..
في الواقع أنا ممتنّة للغاية لملاحظاتك القيّمة التي أغنت المقال، وجعلته أكثر سلاسة ووضوحاً.
شكراً لمرورك ولكلماتك العطرة.
تحياتي.